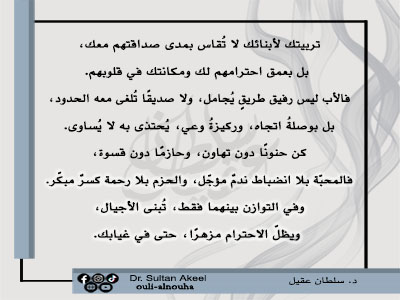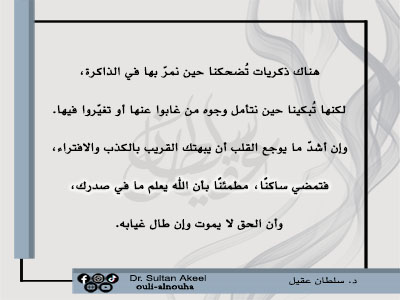قد تناولت في “مدونة أولي النهى” هذه المقالة بعنوان حين يغدو الإيمان جسرًا بين اللذة والخلود :
رؤانا عن نعيم الدنيا لا حدود لها، نرسمها بمتاعها ولذّاتها…
أما تصوّراتنا عن نعيم الآخرة، فكثيرًا ما تكاد تكون معدومة، لما تحمله من حسابٍ وجزاء.
لكن صدق شعورنا بالآخرة وإيماننا بلقاء الله، هو المِقوم الحقيقي للفوز بالحياتين معًا.
قال تعالى:
﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: 44].
ومن صدق قلبه بإيمان لقاء ربّه، نال سكينةً لا تزول، ونعيمًا لا يفنى، حتى يبلغ دار القرار.
ففي كل صباح تتجدد الحياة أمام أعيننا بفتنتها، يشرق النهار على مشاهد من البهجة، وتخطفنا ألوان الدنيا التي لا تنتهي من متاع وزينة. نعيش وكأن العمر رحلة قصيرة خُلقت لنستنفذها في جمع ما يلمع ويبهج، حتى تترسخ في أذهاننا صورة عن الدنيا تكاد تكون بلا حدود، وكأنها نهاية المطاف، بينما تبقى صورتنا عن الآخرة مشوشة ضبابية، تختزل في مشاهد الحساب والميزان، والرهبة من يوم لا مفر منه. هذا الخلل في الرؤية يجعلنا نميل بالكلية نحو ما هو فانٍ، ونغفل عما هو أبقى، بينما اليقين بالآخرة لم يُطلب منا ليحرمنا الدنيا، بل ليهذب سعينا ويمنح أعمارنا معنى يليق بها. وقد تناولت ضمن مدونة أولي النهى بعض هذه المعاني في حديثي حينما تسمع “لا ظلم اليوم”… يطمئن قلبك رغم كل ما مرّ بك.
إن القلب حين يُترك للدنيا وحدها يلهث عطشًا لا يرتوي. يظن المرء أن المزيد من المال سيكفي، أن لذة الجسد ستسكن الروح، أن رفعة المكانة ستملأ فراغه، لكنه يكتشف مع كل نيل جديد أن الشغف لم ينطفئ، بل تجدد الجوع بأشد مما كان. كأن الدنيا مصممة لتقول لك: لست الغاية. أما حين يصدق الشعور بالآخرة، فإن الروح تجد نبعًا آخر للشبع، حيث يهب الله الطمأنينة لمن أيقن أن وراء كل جهد جزاء، ووراء كل ألم عوضًا، وأن ما عنده لا يزول ولا يبهت. هنا فقط يفهم الإنسان المعنى العميق لقوله تعالى: ( وما عند الله خير وأبقى ) “القصص: 60” .
نحن كثيرًا ما نختزل الآخرة في الخوف، فنفر منها ولا نذكرها إلا في مواسم الموت أو الفقد، بينما الآخرة وعد قبل أن تكون وعيدًا. إنها دار الكرامة التي يتجلى فيها عدل الله ورحمته، حيث يقال لأهل الإيمان: “قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا” [الأعراف: 44]. ذلك النداء الذي سيغدو لحظة الفرح الأعظم، حين يتبدد كل شك، ويتحول الصبر إلى فوز، والخطى المتعبة في الدنيا إلى ابتسامة سرمدية. إن هذا المشهد وحده كفيل بأن يغير وجه الحياة كلها، لو جعلناه حاضرًا في وجداننا.

لكن التوازن هو الحكمة، فالله لم يطلب منا أن نعتزل الدنيا أو نكره زينتها، بل أن نراها بما هي عليه: ممر قصير. العمل فيها عبادة، والتمتع بها شكر، والبذل فيها امتحان. فالمؤمن حين يجمع بين الرؤية للدنيا واليقين بالآخرة، يعيش حياتين في وقت واحد؛ يتمتع بزهرة الدنيا وهو مطمئن أن ثمرة الآخرة في انتظاره. عندها يصبح المال وسيلة للكرم لا قيدًا، والمتعة استراحة لا إدمانًا، والمكانة تكليفًا لا غاية. هذه الرؤية المزدوجة هي التي ترد القلب إلى اعتداله، وتجعله يسير بخفة لا بثقل، لأنه يعلم أنه عابر سبيل.
ولعل أجمل ما في الإيمان بالآخرة أنه لا ينتزع الفرح من الدنيا، بل يضاعفه. لأنك حين تذوق نعمة صغيرة وتعلم أن وراءها نعيمًا أعظم، فإن طعمها يتضاعف. وحين تواجه فقدًا أو مشقة، فإنك لا ترى فيه نهاية مأساوية، بل جسرًا نحو حياة أوسع. هكذا يتعلم القلب أن ينظر إلى اللحظة بعينين: عين ترى الدنيا بفتنتها، وأخرى ترى ما وراءها. في هذا الجمع، يكمن السلام الذي يبحث عنه الجميع بلا استثناء.
إن صدق الشعور بالآخرة هو الذي يحررنا من الاستعباد للدنيا. ليس بالخطاب ولا بالتكرار الذهني، بل بالشعور الحي الذي يسكن القلب ويعيد صياغة اختياراته. فإذا آمن المرء أن كل كلمة سيحاسب عليها، فإنه ينتقي حديثه بصدق. وإذا آمن أن كل ألم له جزاء، فإنه يبتسم وسط العاصفة. وإذا أيقن أن كل نعمة مؤقتة، فإنه لا يتشبث بها حتى يهلك، بل يشكرها ويمضي. ومن هنا، يكون الإيمان بالآخرة ليس نقيضًا للحياة، بل قوتها الأعمق.