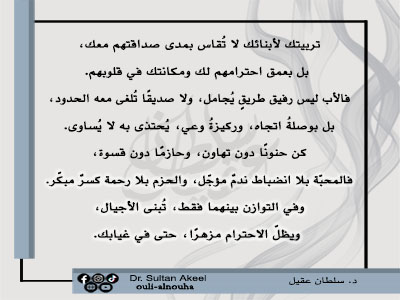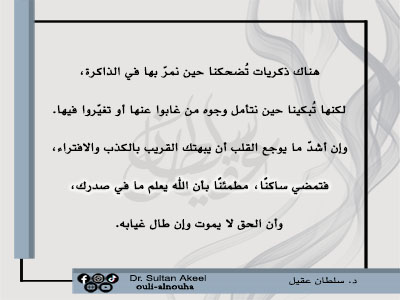الثقة لا تُنتزع في لحظة، بل تُبنى بتراكم المواقف، والمكانة بين الناس لا تُمنح بقرار، بل تُصاغ من صدق المعاملة وثبات الأخلاق. وعندما يهدم الإنسان بيده ما بناه لنفسه، لا يملك بعدها أن يُطالب بالمكانة نفسها التي أسقطها هو بنفسه. فالخطأ أمر إنساني مقبول، لكن التكرار المتعمّد، والاستهانة المتكررة، لا يُغتفران، لا لأن الآخرين ذات قلوبٍ قاسية، بل لأنهم يُدركون أن ما تكرر ليس خطأ، بل منهج. وقد تناولت ضمن مدونتي “أولي النهى” هذا المفهوم الدقيق بعنوان سامح من أخطأ، لكن لا تُبرر لمن يتعمّد الإساءة ، للفرق بين الزلات العابرة والسقوط المتعمد، من خلال المقولة:
“كل شخص له فرصة أخرى… إلا من حطم مكانته بيده، وكل خطأ يُقبل التسامح… إلا تعمد الإساءة وتكرارها، أبداً لا يُغتفر.”
البشر يخطئون، هذا أمر لا جدال فيه، لكن الفارق الجوهري ليس في وقوع الخطأ، بل في كيفية التعامل معه بعد وقوعه. من يُخطئ ثم يعتذر، ويتغير، يُمنح فرصة. أما من يُخطئ، ويعتذر شكلياً لتمرير موقف، ثم يُكرر، فهو لا يطلب مسامحة، بل يُطالبك أن تتقبل أذاه كجزء منك. وهذا في جوهره ليس ضعفاً في اعتذاره، بل ازدراء لكرامتك. فكلما سامحت، عاد، وكلما تغاضيت، تمادى، حتى يُصبح التسامح غفلة، وتتحول الطيبة إلى قبولٍ ضمني للإهانة.
إن من حطّم مكانته بيده، لا يملك أن يُطالب الآخرين بأن يرفعوه كما كان. فكل مقام يُهدم بالإصرار على الخطأ، وكل صورة جميلة تسقط بالتكرار المتعمد للأذى، تحتاج وقتاً طويلاً لتُرمم… وقد لا تُرمم أبداً. لا لأننا لا نغفر، بل لأننا نُدرك أن بعض الانكسارات لا تُبنى من جديد، وأن بعض الكلمات لا تُنسى، وبعض السلوكيات لا تُمحى مهما طالت الأعذار. فالتسامح لا يعني المحو الكامل، بل القدرة على تجاوز ما يُمكن تجاوزه… لا تبرير ما لا يُمكن احتماله.
في العلاقات، لا أحد كامل. لكن هناك خيط رفيع بين العفوية والتعمد، بين الهفوة والتكرار، بين الضعف البشري والنية المبيتة. وحين تشعر أن الإساءة التي تُصيبك لم تكن لحظة انفعال، بل قراراً داخلياً تُلبِّسه الظروف، فإنك لا تكون أمام خطأ… بل أمام منهج. وهذا المنهج هو ما يجعلنا نُغلق باب العودة، لا لأننا لا نُحب، بل لأننا نُحب أنفسنا أكثر من أن نُعرّضها لمزيد من الانكسارات.
بعض الأشخاص يعتقدون أن المحبة تعني فتح الباب كل مرة. وأن العلاقة الحقيقية لا يجب أن تتأثر بتكرار الأذى، وهذا فهم مشوّه. المحبة لا تُقاس بعدد مرات التسامح، بل بقدرتك على منع من تُحب من أن يُسيء إليك. فإن فشلت في ذلك، فأنت لا تحمي العلاقة، بل تُشارك في تدميرها. التسامح الذكي لا يعني النسيان، بل الاحتفاظ بالود دون إعادة نفس السيناريو المؤلم. والحد الفاصل هنا هو أن لا تسمح لأحد أن يُكسر احترامه لك مرتين.
الكرامة الإنسانية لا تطلب العداء، لكنها لا تسمح بالاستهانة. قد تسامح مرة، مرتين، لكن عندما تتحوّل العلاقة إلى حقل ألغام لا تعرف متى ينفجر، فأنت تعيش داخل توتر لا يشبه الحب. ومن يحبك حقاً لن يُجرب صبرك، ولن يختبر قدرتك على الغفران، بل سيُجتهد أن لا يُعيد إليك لحظة الوجع ذاتها. أما من يُعيدها… ويُعيدها… ثم يتحدث عن المحبة، فهو لا يُدرك الفرق بين الحب والتسلط العاطفي.
المكانة التي نخسرها بتصرفاتنا، لا تُعاد عبر الاعتذار، بل ببناء جديد طويل الأمد، يبدأ من فهمنا لخطورة ما فعلنا. فإذا لم يفهم من أخطأ كيف كسر ما بيننا، فكل حديث عن البدء من جديد هو مضيعة للوقت. والكلمات مهما كانت منمقة، لن تُعيد الثقة، بل تجعل الجرح أعمق حين نكتشف أن من أمامنا لا يزال هو… لم يتغير. لذلك، ليس من القسوة أن نُغلق الباب، بل من الحكمة. لأن إعادة منح فرصة بلا وعي… هي رخصة لتكرار الكسر ذاته.
في بيئة العمل، في الأسرة، في الصداقة، وحتى في العلاقات العاطفية… يتكرر النمط ذاته: من يستهين بمكانته، لا يلوم إلا نفسه إن فُقد احترامه. البعض يُهين نفسه عبر كثرة تجاوزاته، ويطلب من الآخرين أن يُعاملونه كما كان. وهذا لا يحدث. لأنك قد تُسامح من جرحك، لكنك لن تنسى كيف جعلك تشك في نفسك، وتُبرر موقفك، وتُعيد تقييم ذاتك وأنت تعرف يقيناً أنك لم تكن سبباً في الألم. الأذى المتعمد ليس ذنباً يُغتفر، بل سلوك يُعاد ضبط علاقتك معه. لا تفتح قلبك لمن يعرف أن فعله يؤذيك ثم يكرره، ولا تسمح للحنين أن يُزيف واقعاً صلباً يقول: “لقد تعمّد.” فإن كان قد فعلها مرة، ثم فعلها ثانية، فلا ثالثة تُمنح له. لأن الاستمرار معه ليس حباً، بل هروباً من واقع مؤلم نحو وهم اسمه: “سيتغيّر.”
الخلاصة:
نعم، كل شخص يستحق فرصة أخرى… إلا من حطّم مكانته بيده. وكل خطأ يُحتمل… إلا ما ارتُكب عن سابق قصدٍ وإصرار. فاحفظ كرامتك، واضبط حدودك، وامنح فرصة لمن يُدرك معناها… لا لمن يُطالب بها ليُعيد جُرحك مرة أخرى.