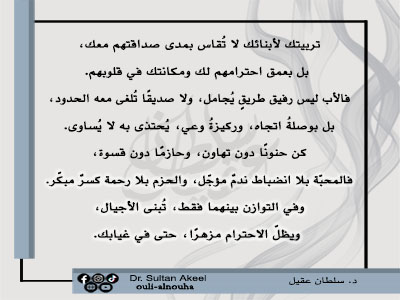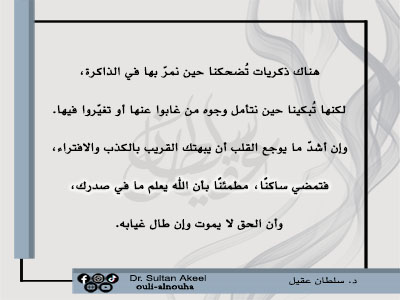قد تتعدد طرق الناس، وقد تتقاطع أهدافهم، وقد يتزاحمون في سُبُلهم المختلفة، لكن الحقائق الكبرى في الحياة لا تتغيّر، وأبرزها: أن كل نجاح يمرّ عبر أخلاقيات الطريق، لا فقط براعة الوصول. النجاح لا يُقاس بمن صعد، بل بمن لم يسقط غيره أثناء الصعود. أن تكون سببًا في إنجاز أحدهم، أو داعمًا في لحظة مفصلية من مسيرته، أو حتى على الحياد الشريف دون أذى، هو أعظم من كثير من الإنجازات الصاخبة التي يُسقط بها البعض كل من حولهم. ولأن كل ما نفعله في طريق الآخرين يعود إلينا، فقد تناولت ضمن مدونتي “أولي النهى” هذا المبدأ العميق بعنوان لا تعرقل طريق غيرك فقد يُمهّد لك نجاتك ذات يوم :
“لا تكن حجر عثرة في طريق نجاح الآخرين، فقد يمنع أحدهم عنك عثرة هلاكك.”
في خضمّ التنافس والتسابق، قد يُخيل للبعض أن عرقلة الآخرين تُمهّد لهم السبيل، وأن إيقاف صعود غيرهم يمنحهم فرصة أكبر للتقدّم. لكن في الحقيقة، النجاح القائم على الإزاحة لا يدوم، بل غالبًا ما يرتدّ على صاحبه في أول اختبار أخلاقي أو إنساني. فحين تقف حجر عثرة في طريق أحد، أنت لا تمنع نجاحه فقط، بل تُعيد صياغة صورتك في ميزان الحياة، وتُعلن عن خلل في نيتك. وما أكثر الذين ظنوا أنهم يحكمون بوابة التقدم، فإذا بهم يقفون على عتبة الندم حين يُمنع عنهم ما منعوه، أو يُقصَون بنفس الطريقة التي أسقطوا بها غيرهم.
السلوكيات الصغيرة قد لا تُلاحظ في حينها، لكنها تُشكّل خارطة سمعتك على المدى البعيد. قد لا يتذكر الناس كلامك الجميل، لكنهم لا ينسون أنك منعت عن فلانًا فرصةً، أو عرقلت ترقية، أو سكتّ عن ظلم، أو حرّضت في الخفاء. وهذه التفاصيل لا تُنسى، ليس لأنها جارحة فقط، بل لأنها تؤثر في مصائر كاملة، ومن هنا فإن كل تصرف يُبطئ غيرك عن هدفه يُقابَل عاجلًا أم آجلًا بتأخير في طريقك أنت. الكون لا ينسى من كسر همّة، ولا من قنّن الدعم عن استحقاق، ولا من جعل ذاته معيارًا للنجاح أو الفشل.
في بيئات العمل، كم من قائد اختبره الله بسلطة، فاستغلها في عرقلة من تحته خشية أن يتفوّقوا عليه؟ وكم من زميل في دائرة ضيّق الخناق على من حوله كي يبقى في الصورة، وكأن الضوء لا يكفي الجميع؟! هذه النماذج لا تُصنع بها مؤسسات عظيمة، ولا تُبنى بها فرق حقيقية. بل يُولد فيها الحقد، وتتآكل فيها الثقة، ويصبح الإنجاز لعبة كراسي، لا مشروع ارتقاء جماعي. وفي النهاية، يُقصى أول من قَصَى، ويُهمّش أول من همّش، لأن الحياة تُحب التوازن، وكل اختلال في نواياك تجاه الناس… ينعكس عليك قبل أن تدري.
وليس شرطًا أن تكون العرقلة فعلًا مباشرًا، فقد تكون بالتقليل، بالتجاهل، بالتأخير المتعمد، بتشويه السمعة في مجالس مغلقة، أو بتضخيم أخطاء عابرة، أو بكلمة يُراد بها تعطيل، لا نصيحة. وقد تكون أكثر خطورة حين تكون صادرة عن صاحب تأثير، فكلما ارتفعت مكانتك، ازداد أثر فعلك، إيجابًا أو سلبًا. ومن أعظم مظاهر النضج، أن تُدرك أن دعم الناس لا يُقلل منك، وأن نجاحهم لا يُهددك، بل قد يكون أحد أسباب تثبيت نعمتك، لأن الله يُبارك للقلوب التي تُحب الخير للآخرين، وتُزيح عنهم ما استطاعت من العقبات، لا أن تزرعها في طريقهم.
النقطة الفارقة أن هذا السلوك قد يُحرّك ندمًا لا يُنسى. كم من إنسان منع فرصة عن غيره، ثم احتاج بعد سنوات من ذلك الشخص نفسه؟ كم من مدير سابق أصبح موظفًا تحت إدارة من حرمه ذات يوم؟ كم من كلمة قيلت في حق أحدهم لتُطفئه، فأنار الله له طريقًا، ثم أصبح شعاعه أكبر من أن يُطفأ؟! وكل من تعامل مع الناس على أنهم درجات تحت قدميه، يُفاجَأ يومًا أنه في حاجة إلى دعوة أحدهم، أو ترشيحه، أو لطفه. وهنا تكون العدالة الهادئة للحياة: أنك قد تجد نفسك تتمنى لمسة نجاة، من يدٍ كنت السبب في تعثّرها.
من زاوية أخرى، العلاقات لا تُقاس فقط بالمواقف المباشرة، بل بالأثر الذي تتركه حين لا تكون موجودًا. هل حين يُذكرك الناس يقولون: كان داعمًا؟ أم يقولون: كم أخرنا وتسبب في سقوطنا؟ لأن العبرة ليست فقط في من وصلت إليهم، بل في كم شخص أوقفت خطواته وأنت تعرف أنك تستطيع المساعدة. والجميل أن يد الخير لا تحتاج قدرات خارقة، أحيانًا يكفي أن تبتعد عن طريق غيرك، وأن تتركه يمرّ بسلام. وأحيانًا أعظم خير تقدمه هو أن لا تؤذِ، لا تُعلق، لا تتدخل بما يعطّل، وأن تحفظ المساحة لغيرك لينمو دون ظلالك.
ومن المعاني الجميلة التي يجدر تأملها: أنك حين تُزيح حجرًا عن طريق أحدهم، قد لا تشعر بأثر ذلك اليوم، لكنك بذلك تفتح بابًا سيُفتح لك لاحقًا. ربما في موقف حرج، في زمن تحتاج فيه دعمًا، أو في فرصة لا يراها أحد سواك. وقد يمنع الله عنك مصيبة كنت لا تعرفها، فقط لأنك اخترت أن لا تعيق حلمًا، أو لم تَسع لإطفاء حماس، أو لأنك ابتسمت في وجه من خاف أن يُقصى… فكان دعمك له سببًا في سترك لاحقًا.
إن العدل الحقيقي لا يتم فقط في المحاكم، بل يتم أيضًا في قلوب الناس وفي دعائهم. كم من دعوة جاءت من قلب مظلوم: “اللهم لا تُريه يومًا يحتاج فيه غيره فيُقصى كما أقصاني.”! وكم من دعوة عكسها: “اللهم كما سهّل لي، فسهّل له.” هذه الأدعية، الصامتة، العميقة، الخارجة من القلب، هي ما يُبقي كثيرًا من الناس في نعمة دون أن يشعروا، أو يُوقف عنهم بلاءً ما كانوا يعرفون أنه قريب. فاختر لنفسك أي الفريقين تريد أن تكون فيه: من يُدعى له، أم من يُتجنَّب في الدعاء؟ وهل هناك فرق أوضح من ذلك في طريق النجاح؟
الخلاصة:
كن عونًا، أو على الأقل لا تكن عائقًا. فمن سار في طريقه دون أن يؤذي أحدًا، هو في مأمن من أن تُنصب له الحواجز لاحقًا. لا تمنع أحدًا من التقدم، فقد يمنع الله عنك تعثرًا به، أو يُرسل إليك بركته ذات يوم، لأنك اخترت أن تكون سببًا في إتمام سعي لا في هدمه.