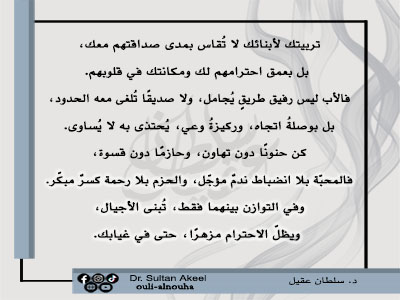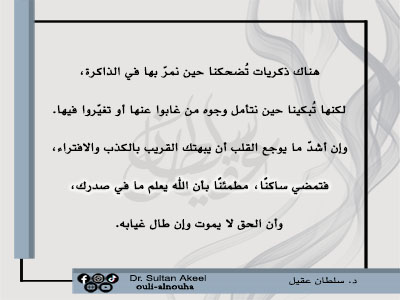الغباء والكبرياء: رفيقا السقوط في حياة البشر، وقد تناولت هذا العنوان في مدونة أولي النهى بالمقولة:
كم هو مؤلم أن يجتمع الغباء والكبرياء في قلبٍ واحد؛ فالأول يعميك عن رؤية الحق، والثاني يمنعك من التراجع عنه، لتخسر وأنت تعلم أنك الخاسر، لكنك تمضي لأن كبرياءك لا يسمح لك بالاعتذار.
في مدونة أولي النهى كنتُ قد تناولت مرارًا كيف أن الغرور ليس سوى قناع هشّ يخفي جهلًا عميقًا، وأنّ الوعي الحقيقي لا يُقاس بذكاء المرء بل بقدرته على التراجع حين يُخطئ. هناك من يملك الحجّة ولا يملك التواضع، ومن يملك المنصب ولا يملك الحكمة، ومن يرى الحقيقة بعينيه لكنه يتعامى عنها لأن الاعتراف بها يجرح صورة نفسه أمام الآخرين. هذا التناقض بين الجهل والغرور هو ما يصنع أخطر أنواع الخسارة: الخسارة الواعية التي ندركها ولا نملك شجاعة تفاديها.
يُقال إن الغباء ليس قلة عقل، بل قلة إصغاء، وإن الكبرياء ليس كرامة، بل هروب من الاعتراف. وكثيرون يظنون أن الاعتذار ضعف، بينما في حقيقته هو أعلى درجات القوة، لأن التراجع يتطلب وعيًا وشجاعة تفوق الثبات على الخطأ. حين يجتمع الغباء والكبرياء، يتعطل العقل عن إدراك ما ينبغي فعله، ويتحوّل القلب إلى ساحة عناد، لا صوت فيها إلا صوت الأنا، ولا مقياس فيها سوى “كيف أبدو”، لا “كيف أكون”. وهكذا يسقط الإنسان في فخٍّ من صنع يديه، لا يطرحه أحد، بل يسقط مختارًا وهو يرفع رأسه ظنًا أنه لا يُهزم.
في العلاقات الإنسانية، يتجلى هذا المشهد كل يوم. كم من صديقين تفرّقا لأن أحدهما لم يستطع أن يقول: “كنتُ مخطئًا”. وكم من حُبٍّ انتهى لأن أحدهما رأى في التنازل إهانة. وكم من بيتٍ تهدّم لأن الغرور كان أقوى من المودّة، ولأن أحدهم ظنّ أن رفع الصوت أقوى من خفضه. الغباء يجعلنا نسيء الفهم، والكبرياء يجعلنا نرفض الفهم الصحيح. تلك هي المأساة الحقيقية، حين يتحول الخطأ الصغير إلى جدارٍ من الصمت، وحين تصبح “الكلمة” التي لم تُقل سببًا في نهايةٍ لا تُصلحها ألف كلمة بعدها.
ولعل أخطر ما يفعله الغباء المتكبر أنه يُقنع صاحبه أنه ذكي. فيبرر لنفسه، ويختار الأدلة التي تريحه، ويُفسر المواقف بما يخدم صورته أمام نفسه وأمام الآخرين. وهنا تتجلى الحكمة القديمة: “من جهل شيئًا عاداه”. فالجهل لا يعادي الآخرين فقط، بل يعادي الحقيقة ذاتها. والمتكبر لا يعيش في واقع الناس، بل في انعكاس صورته عليهم. لهذا يبرع في تبرير أخطائه، وفي إقناع نفسه أن الجميع دونه فهمًا ومكانة. لكنه حين يخلو إلى نفسه، يشعر بالهزيمة التي لا تُقال، وبالخواء الذي لا يُرى.
حين يتحد الغباء والكبرياء، تنشأ نسخة جامدة من الإنسان، لا تتغير، لا تتطور، لا تتعلم. لأنه لا يعترف بخطأ، ولا يستمع لنقد، ولا يفرّق بين الكرامة والغرور. إن هذا التحالف الداخلي بين الجهل والعناد هو ما يمنع النضج، وما يقطع على الإنسان طريق الحكمة. فالحكمة لا تُولد إلا حين يتواضع المرء أمام الحقيقة، ويعترف أن الخطأ جزء من بشريته لا نقيض لها. في المقابل، يعيش المتكبر حياةً ظاهرها صلابة، وباطنها هشاشة، لأن كل ما فيها قائم على الخوف من الاعتراف.
وفي مدونة أولي النهى طالما أشرت إلى أن أقسى الخسائر هي التي يشارك فيها الإنسان بوعيه. أن ترى نفسك تخسر، وأن تدرك أنك السبب، وأن يمنعك كبرياؤك من التراجع، فذلك عذابٌ مضاعف. كثيرون يظنون أن الألم يأتي من الفقد، لكن الحقيقة أن أعمق أوجاع النفس تأتي من الداخل، من صراعٍ بين معرفة الخطأ والتمسك به. وهنا يفترق الأذكياء عن الجهلة: الأذكياء يُراجعون أنفسهم، أما الجهلة فيراجعون الآخرين بحثًا عن شماعةٍ يعلقون عليها فشلهم.
ليس المطلوب أن نكون بلا كرامة، بل أن نفرق بين الكرامة والكبر. الكرامة تحفظك من الإهانة، أما الكبر فيمنعك من التعلم. الكرامة تعيدك إلى نفسك، أما الكبر فيعزلك عنها. والفرق بينهما دقيق لكنه جوهري: الأول يقوم على الوعي، والثاني على الوهم. ومن تأمل في قصص الأنبياء والعظماء وجد أن التواضع كان سرّ رفعتهم، وأن كل من أسرف في الغرور انتهى إلى العزلة أو الندم. فالله لا يرفع المتكبر، ولو كان عالمًا، ولا يهين المتواضع، ولو كان بسيطًا.
ولعلنا نحتاج أن نعيد تعريف الاعتذار؛ فهو ليس تنازلًا، بل إصلاح. وهو ليس خضوعًا، بل نضج. حين تعتذر، فأنت لا تهزم نفسك، بل تنقذها من الغرور. حين تراجع موقفك، فأنت لا تتراجع عن كرامتك، بل تؤكد إنسانيتك. العاقل يدرك أن الاعتذار لا يُقلل من قيمته، بل يرفعها، لأنه يُعلن أن لديه من الوعي ما يكفي لتمييز الخطأ، ومن الشجاعة ما يكفي لتصحيحه. أما الجاهل المتكبر، فيمضي في طريقه وهو يعلم أنه على باطل، لكنه لا يحتمل أن يقول “عذرًا”. وهنا تكون خسارته الأكبر: خسارة النفس قبل العلاقات، وخسارة الاحترام قبل الموقف.
الخلاصة: الغباء وحده مؤلم، والكبر وحده مدمّر، لكن اتحادهما كارثة روحية.
فالأول يُغلق العقل، والثاني يُغلق القلب.
فليس الذكاء أن تُقنع الناس، بل أن تُقنع نفسك بالحق ولو خالف هواك.