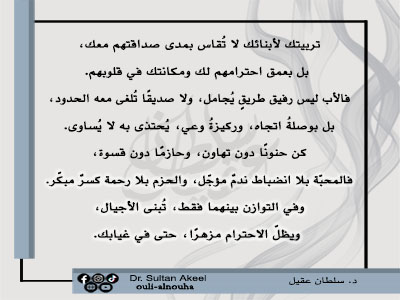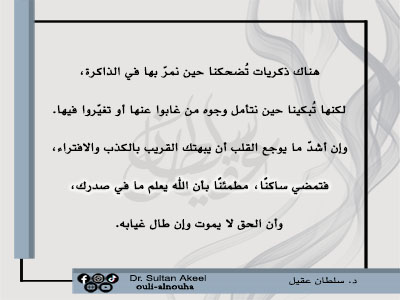تناولت في مدونتي “أولي النهى” هذه القصة الادارية القصيرة بعنوان القائد الذي يزرع الثقة… ويحصد الإنجاز ، ففي إحدى الشركات الكبرى، كان الموظفون يتناقلون قصة غير مكتوبة، لكنها حقيقية في أعينهم. مديران توليا قسمين متجاورين: أحدهما اسمه رائد، والآخر سليم. كلاهما حاز على أعلى الدرجات الأكاديمية، وكلاهما يمتلك سنوات طويلة من الخبرة. لكن الفرق بينهما كان واضحاً دون أن يُقال. في قسم رائد، كانت الاجتماعات مساحة مفتوحة للرأي، يُمنح فيها كل موظف فرصة للكلام، ويُشكر كل إنجاز ولو كان بسيطاً. إذا أخطأ أحدهم، احتواه. وإذا تألق آخر، احتفى به. أما في قسم سليم، فكانت الأحاديث الجانبية تغذي القرارات، يُحاسب الموظفون بناءً على ما يُنقل إليه، لا ما يحدث أمامه. عُرف عنه أنه لا يثق بأحد، ولا يُشرك أحداً، وكانت كلماته المفضلة: “سمعت أن فلاناً…”. لم تمضِ سنة حتى امتلأ قسم رائد بالحيوية والمبادرات، في حين تآكل قسم سليم بالصمت والاستقالات والاحتراق.
القصة لم تكن عن الذكاء، بل عن الثقة، ولم تكن عن الخبرة، بل عن الإنصاف، وتسطرت المقولة في:
“القائد الملهم لا يصنع النجاح وحده، ولا يصدر أحكامه من مقعد الاستماع السلبي.
إنه يزرع الثقة في فريقه، ويحصُد بها الإنجاز.
لأن القيادة الحقيقية تبدأ حين يصعد القائد برفقة من آمن بهم،
لا حين يُصغي للشك ويخذل من وقفوا معه”
هذه المقولة ليست فقط خلاصة تجربة، بل دعوة لإعادة تعريف القيادة لا كسلطة بل كشراكة مسؤولة.
في عالم المنظمات الحديثة، لم تعد القيادة مجرد وظيفة تنفيذية ترتبط بالسلطة والقرارات اليومية، بل أصبحت مفهوماً أكثر تعقيداً وإنسانية. القائد الحقيقي لا يُقاس بعدد التقارير التي يوقّعها أو بالقرارات التي يصدرها، بل بقدرته على التأثير في من حوله. إنه ذلك الشخص الذي يُشعل في النفوس شعور الانتماء، ويُحرك الطاقات نحو أهداف مشتركة. حين يغيب هذا النوع من القادة، تصبح الفرق مجرّد أدوات تنفيذ، ويحلّ الصمت محلّ الإبداع، وينتشر الخوف بدل الثقة.
الثقة ليست ترفاً قيادياً أو سلوكاً مثالياً، بل هي أساس لا تستقر أي قيادة حقيقية بدونه. فكيف نثق بقائد يُصدّر قراراته بناء على إشاعات سلبية؟ وكيف نطمئن في بيئة عمل يُصغي فيها المسؤول لما يُقال لا لما يحدث؟ القائد الذي يُرعي أذنه لكل حديث جانبي دون تحقق، يتحوّل تدريجياً إلى أداة شك، وتتحول قراراته إلى مصدر تهديد لا تطور. الثقة هنا لا تُبنى من خلال العبارات، بل من خلال أفعال واضحة، وإنصاف دائم، ورفض للأحكام السريعة.
القائد الملهم يرى فريقه كامتداد له، لا كخلفيةٍ تُزيِّن نجاحه الشخصي. يعرف أن الإنجاز لا يتحقق إذا شعر الموظف أن مجهوده سيُمحى من التقرير النهائي. التواضع القيادي لا يعني التنازل عن الدور، بل الاعتراف بأن النجاح الجماعي أكثر أصالة وثباتاً من النجاحات الفردية الزائفة. وهذا القائد يُشرك فريقه في القرار، ويحتفل بهم في الإنجاز، ويذكرهم في لحظات التقدير، لأنهم هم من كانوا خلف كل خطوة للأمام.
في كثير من البيئات، تسود ثقافة المدير الذي يحتكر القرارات، ويصعد بمفرده، ويتعامل مع موظفيه كمنفذين لا شركاء. هذه الثقافة ليست فقط مرهقة للفريق، بل مدمّرة للمنظمة على المدى الطويل. الموظف الذي يشعر بأنه مجرد رقم أو وسيلة، لن يُبدع، ولن يبذل فوق الحد الأدنى من الجهد. وعلى العكس، الموظف الذي يشعر بأن رأيه يُؤخذ، وأن إنجازه يُقدّر، سيمنح المنظمة قلبه لا وقته فقط وهذا ما يطلق عليه في بيئة الأعمال بتمكين الموظف.
القيادة الناضجة تمنح الثقة أولاً، ثم تُطالب بالمسؤولية. القائد الذي يقول: “أنا أثق بك”، يخلق بيئةً تفيض بالاحتمالات. إنه لا يخاف من ارتقاء من حوله، بل يُشجعه، ويُمهّد له الطريق. القائد الذي يُشعل الثقة يُنتج جيلاً من القادة من بعده، بينما المدير الذي يُشعل الخوف، يصنع جيلاً من الصامتين والمرعوبين. وكل بيئة عمل ناجحة، خلفها حتماً قائدٌ يثق ويُحتَرم، لا يُراقب ويتحكم فقط.
هناك أمثلة كثيرة لقادة فقدوا قوتهم لا بسبب قلة المعرفة، بل بسبب عزل أنفسهم عن الحقيقة. حين يحيط القائد نفسه بدائرة من المجاملات، ويستمع فقط لما يريده أن يُقال، فإنه يبني وهماً لا واقعاً. والخطورة الأكبر حين تُبنى قرارات حساسة – كالتقييم، الترقية، أو إنهاء العقود – بناءً على أصداء غير موثوقة، أو انطباعات لا تُراجع. هنا، تنهار ثقة الفريق، ويبدأ الانسحاب الداخلي الصامت.
ومن هنا تنبع دعوة صادقة لكل من يشغل موقعاً قيادياً في أي مجال: لا تنتظر وقوع الخطأ لتراجع قراراتك، راجع نفسك في لحظات النجاح. اسأل: من كان سبب هذا الإنجاز؟ هل نسبته لنفسك؟ أم شاركت الفريق الفضل؟ هل أنصفت من يعملون معك، أم استسلمت للآراء المنقولة دون تحقق؟ راجع مسارك، وأعد تقييم أدواتك، وابنِ قيادتك على أساس الثقة، لا على قاعدة الهيمنة.
إن القائد الذي يمنح الآخرين المساحة ليتألقوا لا يخسر بريقه، بل يزداد توهّجاً في أعينهم. والثقة التي يمنحها لأفراد فريقه اليوم، ستكون السند له في الغد، والميراث الحقيقي الذي يتركه خلفه حين يُغادر. فالقيادة ليست لحظة تُمارَس، بل قصة تُروى، وأثر يُخلّد.