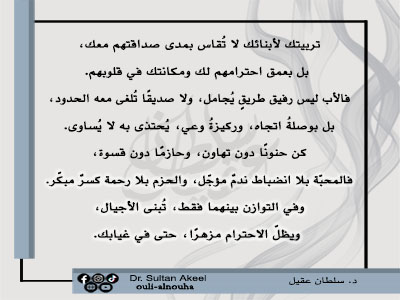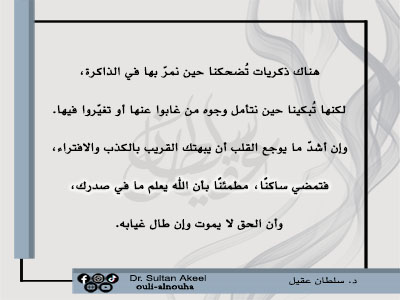في العلاقات الإنسانية، لا تكون الطعنة دائماً من غريب، بل من الذين تمنينا قربهم، ومنحناهم فيضاً من مشاعر لم نقلها لأحد. الذين صدقناهم، وجمّلنا حضورهم في أعماقنا، وأعدنا تشكيلهم بصورة لم يُطلب منهم إلا أن يكونوا أوفياء لها. نزرع لهم الأمان، فيردّونه قلقاً. نمنحهم النقاء، فيسقونه بالخذلان. وما أقسى الخيبة حين تأتي من أولئك الذين كنا نراهم مرآة لصدقنا. وقد تناولت ضمن مدونتي “أولي النهى” هذه اللحظات الوجدانية بعنوان خيبات القلوب النقية… تُجبرها عدالة الله سبحانه والتي تلامس عمق الخذلان، حين يُساء فهم النقاء، ويُقابل العطاء بالجحود، وتبقى القلوب تنتظر إنصاف رب كريم بعد أن سقطت الأقنعة، وقد سطرت المقولة:
كم كانوا يتمنون أن يلتقوا بأناس أصحاب قلوب نقية وذوات صافية،
كم كانوا يبحثون لهم عن السعادة بكل ما استطاعوا،
كم كانوا يُشيدون لهم قصوراً في خيالاتهم،
كم كانوا يتمنون أن لا يجدوا منهم ما يُسوئهم،
كم كانوا لا يتخيلون منهم تلك الحيل والنكران وخيبات الأمل،
كم كانوا يرون حيلهم ودسائسهم بعينٍ سوية… حتى أصابتهم سهامهم بكل غدر وألم.
كم كانوا يشعرون بتسلط طاقاتهم السلبية، فاستطعمَتها قلوبهم بكل مرارة وحرقة.
كم كانوا يتمنون مسامحتهم قبل الرحيل،
كم كانوا يتمنون أن لا يكونوا خصومهم في محكمة قاضيها الله سبحانه وتعالى.
كم كنتم وكم كانوا… فكلٌّ إلى الملتقى في يوم المآب.
بعض الخيبات لا تأتي من العدو، بل من أولئك الذين تمنينا قربهم، وأعطيناهم من أنفسنا أكثر مما ينبغي. نراهم ملاذاً، فنُهديهم الطمأنينة دون شروط، ونظن أنهم حائط القلب الأخير. لكنهم، وبدون سابق إنذار، يُسقطون كل شيء، وكأنهم لم يكونوا يوماً. فإن أشد ما يُنهك القلب هو أن تُخذل من حيث تمنيت النجاة. أن تُصاب في أصدق أحلامك، لا لأنك كنت ساذجاً، بل لأنك كنت طيباً. تمنيت أن تزرع ورداً، فإذا بك تُفاجأ بأشواكٍ مغروسة في عمقك، بأيدٍ كنت تحلف أنها لا تؤذي.
نعم… كانوا يتمنون السعادة لنا، حتى إذا أوجعناهم خطأً، اعتذرنا. أما هم، فكانوا يُخطئون عن وعي، ثم يُدينوننا على ردة الفعل، ويتهموننا أننا بالغنا، وأننا لم نكن متسامحين بما يكفي. نعم… بنينا لهم قصوراً في الخيال، وعلّقنا على جدرانها أمنيات، وصفاء نية، وذاكرة ممتلئة بلحظات ظننا أنها خالدة. لكنهم هدموا القصور فوق رؤوسنا، وساروا كأن شيئاً لم يكن، وكأن الخذلان عادة تُمارس لا فعل يُحاسب عليه. نعم… كنا لا نتخيل أن يأتينا النكران من جهتهم، لأنهم حين حضروا أول مرة، بدوا لنا مرآة لما نحمل في أنفسنا. ظننا أن من يشبهنا لا يؤذينا، ولم ندرك أن التشابه لا يصنع النوايا.
ورغم الألم، لم نكن نبحث عن الانتقام، بل كنا نتمنى منهم فقط كلمة تعيد اعتبارنا، موقفاً يُعيد التوازن، حتى لا نحملهم معنا إلى يوم تُكشف فيه السرائر وتُعلن فيه النيات. لكنهم أصروا على أن يرحلوا بلا تفسير، أن يُشعروك أنك أنت المخطئ، وأن يُسلّموا قلوبهم للغموض، وأن يُسكتوا أي حديث يمكن أن يُنقذ. وعندها… لم يبقَ لك إلا الصبر، والدعاء، وانتظار عدالة الله.
فحين يتقاطع النكران مع الصمت، فإنك لا تعود مكسوراً فقط… بل مشوشاً. تبدأ تراجع ذاتك، تُعيد حساباتك، وتكتشف أنك في كل مرة كنت تبالغ في الثقة، وتُجمّل الصورة أكثر من اللازم، وتنسى أن الواقع ليس كما تراه النية، بل كما يكشفه السلوك. وبعد كل ذلك… تهمس لنفسك: كم كنتم وكم كانوا؟ كم مرة سامحتهم قبل أن يطلبوا؟ كم مرة دافعت عنهم أمام قلبك؟ كم مرة قلت إنهم لا يقصدون؟ وكم مرة… كنت تكذب على نفسك لتحتفظ بصورةٍ جميلة لهم؟
لكن الله لا ينسى. وإن مضت الأيام بهم في غفلتهم، فإنها تمضي بك في وعيٍ متزايد. من فقدتهم لم يكونوا لك، ومن خذلك كان درساً لا خيبة. ومن خاف أن يواجهك، فلن يستطيع أن يُنكرك أمام الله يوم المآب.
الخلاصة:
ما من خيبة تأتي من النقاء إلا ويجبرها الله بحكمة.
وما من خصومة صامتة إلا وتُعرض في محكمة العدل يوم لا يُظلم فيه أحد.
فدع قلبك نقياً… واترك الحساب لمن لا يغفل ولا ينسى.