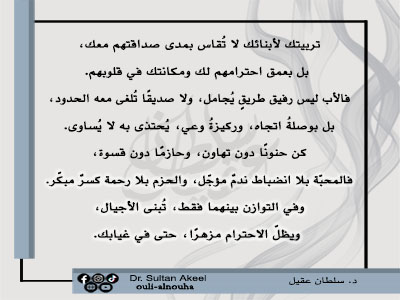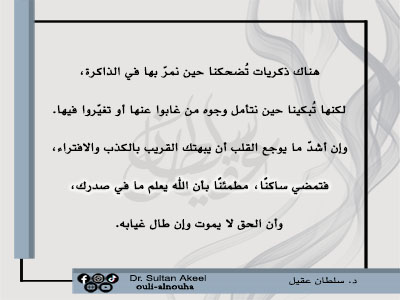في رحلتك مع الحياة، قد تتخيل أن العطاء اللا مشروط هو قمة النبل، وأن إجهاد نفسك لإرضاء الآخرين دون اعتبار لاحتياجك هو تجسيد للمحبة. قد تظن أن التضحية الدائمة هي الثمن الواجب لتبقى محبوباً، أو حاضراً، أو مقبولاً. لكن الحقيقة التي تصدمك لاحقاً أن بعضهم لا يرون في عطائك إلا واجباً، ولا يلاحظون تعبك، ولا يفكرون بسؤالك: “هل أنت بخير؟” وقد تناولت ضمن مدونتي “أولي النهى” هذه الحالة المؤلمة من الإنهاك النفسي خلف قناع العطاء بعنوان لا تُرهق نفسك لإسعاد من لا يراك إلا حين يحتاجك، فالمقولة:
“قد تظن يوماً في رحلة الحياة أنك إذا أجهدت نفسك دون رحمة بها في إرضاء من حولك، فبذلك قد فزت برؤية السعادة تغمر أيامهم! ولكنك تجاهلت أن من يقبل أن يكون سعيداً على حساب راحتك وإجهادك… فهو لا يستحق عطائك. رفقاً بنفسك ولا تجهدها… ففي إهمالها ظلمٌ لك ولها.”
هناك شعرة رفيعة بين العطاء النقي والاستنزاف الصامت، بين الكرم الفطري والتضحية المؤذية. حين تبدأ في منح وقتك، طاقتك، أعصابك، وراحتك النفسية كي تُرضي الآخرين باستمرار، فأنت تدخل منطقة رمادية لا تعرف فيها من تُحب بصدق… ومن اعتاد على وجودك كأنه حق. العلاقات الحقيقية لا تُرهقك، لا تُشعرك أنك مُطالب دائماً بأن تُبرر، أو أن تُلغي أولوياتك كي تتناسب مع مزاج غيرك.
الذين يُحبونك بصدق لا يسمحون أن تُنهك لأجلهم، ولا يقبلون أن يكون اتزانهم على حساب اختلالك، ولا سعادتهم قائمة على تعاستك. من يقبل أن يراك تُجهد نفسك، وتُكتم أنفاسك، وتُؤجل راحتك… ثم يبتسم لأنه وجدك كما اعتاد، لا كما تحتاج، هو لا يُحبك، بل اعتاد على خدماتك النفسية. وما أسوأ أن يتحول قلبك إلى آلة لتلبية العاطفة دون أن تُشبع حاجاته هو.
الإرهاق العاطفي لا يبدأ بصراخ، بل يبدأ بلحظات صامتة تُكرر فيها: “لا بأس”، “أنا بخير”، “كل شيء على ما يرام”، وأنت في الحقيقة غير ذلك. تبدأ بالتبرير، ثم التنازل، ثم الكتمان. وتكتشف لاحقاً أنك أصبحت مسؤولاً عن راحة الجميع… ما عدا نفسك. أنك نسيت صوتك الداخلي، وقراراتك الصغيرة، وأبسط حقوقك في أن تقول: “تعبت.” هذا الصوت الذي تُسكتُه لأجل غيرك… سينهض يوماً ما، لكن بعد أن تُنهك كلياً.
لا أحد يستحق أن تُضحّي بنفسك لأجله ما لم يُبادلك هذا التوازن. العطاء جميل، لكنه يجب أن يكون في حدود لا تمس كرامتك ولا تُهدر طاقتك. فلا ترفع سعادة أحد إن كانت ستسحق استقرارك، ولا تُلبِّي نداءاتهم إن كانت على حساب صمتك الداخلي. السعادة التي تُبنى على إجهادك لا تدوم، لأنها لا تأتي من محبة، بل من استغلال مموّه باسم العلاقة.
من الحكمة أن تُدرك أن طاقتك النفسية مورد محدود، لا يمكن إنفاقه على الجميع دفعة واحدة. كن كريماً، لكن لا تكن مُنهكاً. كن معطاءً، لكن لا تُهمل نفسك. لأنك إن لم تنتبه، ستجد نفسك في نهاية العلاقة لا تملك لا طاقة، ولا صوت، ولا احترام. وكلما تعبت أكثر… أصبح عطاؤك واجباً لا جميلاً. وكلما منحت أكثر… خفت أثرك، لا لأنك أقل، بل لأنهم اعتادوا على وجودك دون مقابل.
رفقاً بنفسك… لأنك حين تُهملها، لا تُجردها من حقها فقط، بل تزرع فيها شعوراً بالخذلان، وكأنك انحزت للآخرين ضدها. رفقاً بها لأنك إذا انكسر شيء فيك من الداخل، لن يُصلحه الآخرون حتى لو أرادوا. عليك أن تكون خط الدفاع الأول عنها. أن تُراعي حاجتها للهدوء، وللتقدير، وللتنفس. لا تُهمل ذاتك في سعيك لأن تكون مثالياً في عيون من لا يُدركون كم تكلفك ابتسامتك.
من يحبك لا يُطلب منه أن يُريحك، بل أن لا يكون سبباً في إنهاكك. أن يعرف متى يتقدم، ومتى يتراجع. أن يرى فيك إنساناً لا وسيلة. أن يُعيد إليك ذاتك حين تغيب، لا أن يُطالبك بالبقاء حاضراً وأنت غائب داخلياً. العلاقات المتزنة لا تُطلب فيها الراحة… بل تكون افتراضية. لا تُشرح فيها مشاعرك مراراً، بل تُفهم من المرة الأولى.
وكم من أشخاصٍ أرهقوا أنفسهم في التبرير والإرضاء والعطاء، ثم في النهاية قيل عنهم: “كان يفعل ما يُريده لنفسه”، “ما كان أحد يُلزمه.” والنتيجة؟ لا أحد قدّر كم كان يُرهق نفسه لأجلهم. لذلك، لا تُراهن على ذاكرة الآخرين… راهن على وعيك بحقك في الراحة، في الحدود، في التقدير.
الخلاصة:
العطاء النقي لا يُرهقك، وإن أرهقك فهو ليس عطاء… بل استنزاف باسم الحب.
احفظ نفسك، ولا تُرهقها لتُسعد من لا يسألك: “هل هذا يُتعبك؟”
ورفقاً بها… ففي إهمالها ظلمٌ لك ولها.