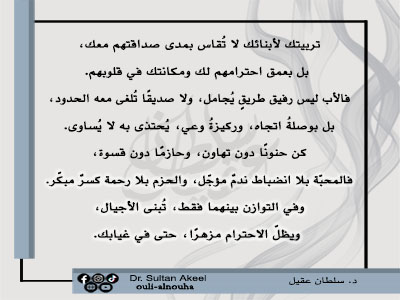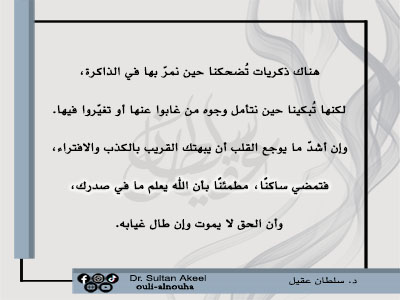تمرّ على الإنسان لحظات لا يُخطئها القلب، لحظات خذلانٍ داخلي لا يأتي من ضعف، بل من تناقض بين ما بذله وبين ما تلقّاه. لحظات يقف فيها المرء أمام مرآته لا ليعدّل هندامه، بل ليبحث في ملامحه عن السبب الذي جعله يُساء الظن به، رغم كل ما فعله بصدق. قد تكون هذه اللحظات هي الأصعب؛ لأنها لا تأتي من عدو، بل غالباً من أقرب الناس، من أولئك الذين أخذوا منك الكثير، ثم أعادوا إليك نظرةً من الشك، أو جملة من الجحود، أو شعوراً بالاتهام الخفي. وقد تناولت ضمن مدونتي “أولي النهى” هذا المشهد النفسي بعنوان من سوء الفهم إلى سلام النفس… الرحيل حكمة لا هزيمة ، والذي يتكرر في حياة الصادقين:
“قد تأتيك لحظات تعصف بك تحمل بين طياتها تساؤلات تشعرك بنقص عطاؤك وسوء أفعالك، رغم أن حديث نفسك يرفضها لأنك قد بذلت الغالي والنفيس. حينها يجدر بك أن لا تطوي تلك الصفحة حتى تبدأ من جديد مع أولئك الذين جعلوا حديث نفسك يعلو فوق حسن أخلاقك وكرم عطاؤك، بل أغلق الكتاب… واستبشر خيراً.”
الشك في الذات لا يولد من فراغ، بل من تكرار الإشارات التي تُشعرك أن ما فعلته لم يُفهم كما أردت. أنك أُسيء الظن بك رغم نيتك النقيّة، وتُرجمت طيبتك على أنها مصلحة، وصبرك على أنه تردد، وصمتك على أنه إدانة. وفي لحظةٍ ما، تبدأ تساؤلاتك: هل كنت مقصرًا فعلاً؟ هل ما قدمته لم يكن كافياً؟ لماذا تحوّل الإحسان إلى مأخذ؟ وتعلو في داخلك أصواتٌ لا تشبهك، لكنها تكاد تُقنعك أنك أنت المشكلة. ومع هذا، هناك في داخلك صوتٌ صغير، هادئ، ثابت، يقول: بل كنت نقياً، وكنت كريماً، وكنت كما يجب.
هذه المفارقة المؤلمة بين حديث النفس وحديث الواقع تُحدث شرخاً لا تلتئم فيه الثقة بسهولة. تشعر بأن قلبك بات موضع اتهام، وأن نواياك تُناقش، وأن تاريخك الجميل معهم أُغلق فجأة، دون اعتذار، دون إنصاف. عندها، يتملكك الشعور المرّ بأنك ضحية لما في قلوب الآخرين، لا لما فعلته حقاً. وأنك مهما بذلت من حسن النية، فإنّ القلوب المظلمة لا ترى إلا ما تُريد. وهنا تكون المفارقة الأكبر: أن تستمر في التبرير، أو أن تختار راحة نفسك، وتغلق ذلك الكتاب كله، لا الصفحة فقط.
ليس المطلوب أن تُقنع الناس دائماً، بل أن تُحسن الظن بنفسك حين لا يُحسن الآخرون الظن بك. أن تُربّت على قلبك وتقول له: “أنت فعلت ما عليك، فلا تُحمّل نفسك وزر سوء فهمهم.” وأن تفهم أن بعض العلاقات تنتهي لا لأنها كانت ضعيفة، بل لأنها بنيت على أعين لا تُبصر النقاء، وآذان لا تُصغي إلا لما يشبهها. وكلما حاولت أن تشرح، زادت المسافة، وكلما برّرت، زاد الغموض، وكأنك في معركة لم تُشارك فيها يوماً، ومع ذلك أصبحت هدفاً فيها.
حين تجد نفسك تُراجع عطاءك لا لتحسّنه، بل لتبحث عن مواضع يُساء فهمك فيها، فاعلم أن الطريق لم يعد نقياً. لأن العلاقات السويّة لا تُربك الداخل، ولا تُشعرك أنك تُحاسب على حسن نيتك. وكلما شعرت أن وجودك يُحمَّل فوق ما يحتمل، وأن حضورك يُثقل عليك لا عليك، فقد آن أوان الرحيل. لا كعقوبة لأحد، بل كنجاة ذاتيّة تُعيد ترتيب كرامتك. وهنا، لا تكتفِ بطَي الصفحة… بل أغلق الكتاب، واكتب فصلك الجديد مع من يُحسن الظن، ويحتفي بالنقاء، ويعرف أن ما يُقال عنك ليس بالضرورة ما فيك.
أحياناً، الاستمرار في العلاقة التي تُربكك أسوأ من الانسحاب منها. لأنك تبقى في دائرة التبرير، وتُرهق نفسك في الدفاع، وتعيش في قلق دائم مما قد يُقال عنك غداً. والكرامة لا تزدهر في هذا المناخ، بل تتآكل ببطء، دون أن تشعر. اغلق الكتاب، لا لأنك ضعفت، بل لأنك أدركت أنك لا تستحق هذا النوع من القلق المتكرر، ولا هذا الظلم الذي يتنكر في هيئة حب. فالمحب لا يُشعرك أنك مذنب، ولا يُربكك بما لا تفهمه، ولا يجعلك تعيد تعريف ذاتك كل صباح لتناسب مزاجه.
حين تُغلق ذلك الكتاب، فأنت تُعلن نهاية قصة لم تُكتب بعدلك، وتبدأ سطراً جديداً لا يشبه ما مضى. هذا ليس هروباً، بل تحرير. تحرير من ثقل الأسئلة التي لا إجابة لها، ومن انتظار التبرير ممن لا يهمه أن يفهم. وعندما تبدأ من جديد، ابدأ بقلب لا يحمل إلا الصفاء، لكن بعقلٍ لا ينسى الدرس. فقد تُمنح ألف فرصة للعطاء، لكن اجعل عطاءك هذه المرة أكثر حذراً، وأكثر توازناً، والأهم: أن يكون مع من يُقدّره.
استبشر، لأن الله لا يُغلق باباً إلا ليفتح آخر. ولا يُريك خذلاناً إلا ليُمهّد لك صدقاً. وكل وجع عابر سيُثمر نضجاً دائماً. وإن شعرت يوماً أن ما فعلته ذهب سُدى، فتذكّر أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأن كل نية طيبة، وكل لحظة صدق، وكل موقف نقاء… كُتب عنده، ولو لم يُفهم عند الناس. فلا تحزن إن أساؤوا الظن، ولا تنهزم إن خانوا التقدير. ما عند الله أعظم، وما سيأتي أجمل.
الخلاصة:
لا تُرهق نفسك في علاقات تُربك فطرتك، ولا تُعدّل صورتك لتناسب ضيق عيونهم. أغلق الكتاب الذي حمل في طياته ظلماً وخذلاناً وجحوداً لصفاء قلبك… واستبشر، لأن الله لا ينسى صدق النوايا، وإن نسيها الناس.